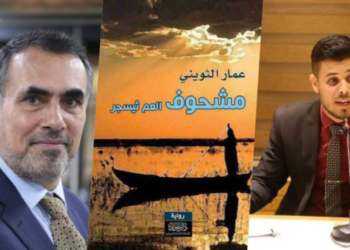ذ. عبدالله علي شبلي ناقد و باحث أكاديمي /المغرب
-*مقدمة :
لعل الهذيان يكون مجديا حين يكون منتجا ، حين يفرخ ، بل يثمر وصولا إلى مراقي المعرفة ، واستكناه أسرارها ، فيتحقف بهذا المعنى نيل البغية ومراد التمني.
هنا يحق لنا أن نتوقف عند الهذيان بدلالة تشكل نقيضا لما يراه العامة ، حيث تصطبغ الكلمة بصبغة مختلفة ، فتكتسي انزياحا في دائرة التفلت والتمنع ، بل وتعانق دائرة الزئبقية التي تسم الشعر وتتوسمه أيضاً.
الهذيان ليس أبداً ، والحالة هذه ، منقصة ولا مذمة ، ولا عيباً يلتصق بذاكرة ممهورة بالخواء والخور ، لكنه يحيل على ارتقاء الهذيان ، ليصير من المراقي التي لا تحصل إلا لذي قريض ، فيتوازي حينها مع الإبداع ، فيستوي غايته المثلى ، مطلبه ومسعاه.
ولعله من أبجديات المعرفة ، أن نقول ونقرر أن الإبداع لا يرتقي ولا يصل منيته بدون الخيال الواسع الذي يضرب الآفاق جيئة وذهابا ، باحثاً عن سموق المعاني وشموخ المبادئ ف” الخيال هو فضاء الشاعر الحر ، الفضاء الذي يحقق له رغباته في الوهم “* 1. وما الإبداع ، في حقيقة أمره شئنا أم أبينا إلا هذيانا بشكل من الأشكال ، لذلك فما أكثر الهذيان المحموم الذي أثمر إبداعا لا نظير له ولا شبيه ، وما حمى المتنبي عنا ببعيد ، أ لا يستيقظ المبدع في أجواف الليالي ، ليخط هذيانه أو أحلامه ومحمومياته ، فيربط كتابه ، ويوثقه رسما ، كي لا يهرب عنه ساعة تعقله واغتساله بماء اليقظة ؟
1 . تقليدية الحطب بين مآرب الحاجة وثقافة البذل والجود :
لاشك في ارتباط ” الحطب ” الرمز بثقافة متجدرة في عروبة الصحراء ، فلا نار بدون حطب ، وأمام رمزية ” النار ” وربطها بالنور والمعرفة والهدى وغيرها من القيم ، فقد يتوارى الحطب إلى الخلف تماما ، كونه هنا وسيلة لا غاية.
ومن وجهة نظر أخرى مخالفة ، تنظر إلى الأمور بمنطق مختلف ، استحضارا لعتبات التلقي بمنظور ” روبرت ياوس ” الذي يعد استباقا معرفيا لتلقي النص ، يحق لنا تحت شرعية ابستيمولوجية خالصة أن نطرح سؤالاً آخر ، يستتبع ما سبق : أ لا يكون حطب النار ذاته ضحية جاءت بها العنونة ، لتوقد النار من أجل شيء آخر غير تحصيل المنفعة ؟
وفي سياق متصل بتحصيل المنافع ، كما اعتاد العرب إشعال النار طلبا للتدفئة ، فقد اشعلوها أيضاً دفعا للجوع ومحاربة للمسغبة ، بل وتوقد أيضاً ترحيبا بالضيف وإرشادا للضال ، ولعل حاطب الليل لا يكاد يميز بين أخضر ويابس – شأنه في ذلك شأن المتكلم الذي لا يعي ما يقول – ، بين أفعى و غصن شجرة تالف تبرد واكتسب نداوة وطراوة ، فهو يجمع ولا يكاد يميز بين صالح وطالح ، هكذا الكلام يغدو مستنبتا في مشتل يومي لما يعيشه العربي في حياته الرتيبة في تعالق مفروض بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية .
أ لا يحق لنا أن نسأل أيضا بطريقة مخالفة : كيف يجمع الهذيان بالحطب ؟ أو كيف يجتمعان هنا قصدا ، في عتبات الديوان الموسوم ” هذيان الحطب ” ؟ أو لنقل بتعبير آخر أكثر دقة وطلبا للتفصيل : من الذي يهدي ؟ ومن الذي يحتطب ؟
وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال ، ورغبة في قراءة إسقاطية أقول : حقا إن الهذيان هنا بلاشك ولا مواربة ، لن يكون إلا شعرا بياتيا ( نسبة إلى الشاعرة طبعا) ، هذا الشعر نفسه ، قد ينظر إليه البعض نظرة تجعله كلاما في أوراق ما يلبث أن يمحو ويزال ، هلوسة ليل يمحوها نهار. وفي منظور آخر – وهو الأقرب معرفيا إلى المتداول النصي – يوسم عند البعض الآخر بالإبداع الراقي ، الذي يسوق أنموذجا ، يشق طريقا رفيعا لمبادئ سامية تنثر حروفا رائقة ، تبتغي نبلا ، تنشر حباً وعدلا ، تجسد موقفا من الذات من الحياة ومن الآخر ، وإن تمترست ايديولوجيا وهذا لا عيب فيه ، تتخذ تموقعا من على ربوة معينة .
لتومض بريقا أو ترسل برقا قاصفا ، ولعله يغدو مفرقعا ومدويا ، حين يستحضر أنات الجوعى، وصرخات الفجع وتأوهات الوجع ، فقرا وظلما وحرمانا ، تبعا لتنامي حروف القصيد البياتي ، وتناسل مرامي حروفه داخل الديوان – الرسالة.
وفي هذه القراءة الأخيرة ،أجدني أتقاطع مع ” باختين ” ، بل يغدو التقاطع مفروضا وإجبارا في مقولته المشهورة ” حيث توجد الدلالة توجد الايديولوجيا حتما ” .
واستتباعا لما سبق أن أثير حول ” هذيان الشاعرة ” ، أطرح سؤالين آخرين أولهما : هل يستنكر الهذيان الشعري الواعي ما يجمع من حطب ليحرق ، من أجل أن يتدفأ به الآخر ، فيغدو ما يحرق ضحية جشع ، أو وسيلة طمع تغدي حقدا دفينا على الآدمية ، على الانتماء ، على الهوية ، أو حتى حسدا أو نقمة وتشفيا ،على التمترس والتخندق والايديولوجيا ؟
وثانيهما : هل يصبح الهذيان الشعري وقوفا مطولا ومنوعا ، بطول القصائد وتنويعات تشكيلها وبناها وصورها ، استحضار لما يحتطب ( بضم الياء) ومن يحتطب ( أقصد الفاعل) وعلة الحطب ؟
والحالة هنا مع السؤالين السابقين ، لن ينتج الوقوف إلا اعتبار الحطب فعلا مشينا ، لأنه لا يقدم غاية الحطب المثلى عند العرب ، باعتباره ينتج ناراً دالة وهادية ، منارة ترشد الجائع والتائه وذا الحاجة إلى حيث الرفد والزاد والأمن والسكن النفسي ، وبذلك تجعل الإنسان يتعالى على الحطب خشبا ، ويتسامى على لغة الخشب ، ولا يتساوى به أبدا ، بل يتسيد ، حيث يغدو سيدا ، ينشر قيم النبالة والكرم الحاتمي .
وتوازيا مع المنحى ذاته ، ونحن نستحضر سيميائية المعنى المرتبطة ب ” نورانية المعرفة ” وعلاقتها بالنار المشعة التي تمحو ظلام الجهل ، وظلمة العالم الهمجي ، التي لن تأتي تقليديا ولغويا أيضاً إلا بالحطب ، لا بالإحتطاب *2 ،
فعلاقة الاحتطاب بالافتعال تجعل الفاعل لا يعرف بغية الحطب ومزيته ، وإنما يشعل ناره وقتما شاء وكيفما شاء وبأي شيء شاء ، فيصير بهذا المعنى تعديا وتجاوزا لحدود المألوف الذي طبع الله عليه الأشياء ، وأصلح عليه أمر الليل والنهار.
وبهذه القراءة الأخيرة ينضج خبز العنوان ، وتتخمر خميرة علائقه ، مبدية سفور أطروحة الشاعرة ، كاشفة خندقة العنوان وتفخيخه المبطن ، فهو ليس كالعناوين السهلة : أحصنة مسرجة مروضة يركبها من لم يألف الركوب ، بل هي حرون منفلتة منيعة ومتمنعة.
2 . اسقاطات الحروف وسيميائية الكلمات ، دلالات التفكيك في لفظتي ” الهذيان ” و ” الحطب ” .
إذا كانت ” هاء ” الهذيان لا تشكل إلا هلوسات قريض واعية ، تتمسك بمنهج ورسالة مختارة بعناية وألق ، فإن ” الذال ” لن تشكل إلا ذاتا بياتية ، لتنضم إليها الياء والألف والنون متتابعة فيشكل رسمها تباعا يناعة لفظ مكتمل باكتمال الدلالة المترتجاة . فيصبح الهذيان : هلوسات ذات بياتية يانعة.
إن الحاء في حطب لن تغدو إلا “احتراقا” بما تحمله من معان ظاهرة ومبطنة ، وددت حقا لو كانت ” حرقة ” ، فحرقة قلب أو حرقة فجيعة قد تصفو بعد لحظات سلوة أو سويعات نشوة ، أما الاحتراق فهو باق مستمر وكينونته أبدية ، كما ان ارتباط الاحتراق بالافتعال ، هو افتعال أيضاً للاحتراق وهو دوام للحرق والتحريق.
أما الطاء هنا في جوف كلمة ” حطب ، فليست إلا طاء طين ، طينة الاحتراق ، ونوعه من الطين ، ليحيل على المحترق و المحروق في ديوان ريم وهو الإنسان طيني التشكيل ، من تربة تشكل فما أقدره على النار ؟
وإذ يحترق الإنسان بما يوقده الإنسان نفسه في احتطابه الأعمى ، ليحرق . لا ليرحق ، كما النحلة وينشر رحيق المحبة والعدل والعلم. يحترق طين الإنسان في دوامة هذا الوقت المعاصر ، الذي يعد عالم حرق بامتياز ، حتى شكل الاحتراق ب ” الباء ” برزخ الديمومة ” ، فهو احتراق لا تبدو نهايته وشيكة ، بل تتعاظم ولا تتقازم ، فيغدو احتراق أهل الطين برزخا أزليا. وكأن التماهي هنا يحيلنا على احتراق الإنسان الأزلي الجهنمي يوم الحساب والميزان العادل الذي لا يظلم ولا يجور أبداً ، فهو ميزان حق و عدل سماوي ، لكن شتان بين هذا وذاك ، فذاك لا يكون إلا هناك ، حيث عدالة أخرى لا توصف ولا تقارن ، ويربأ بها هنا ، كونها عدالة تحرق لتستعيد ثأر من حرق هناك ، فتورق وتغدق ، أما هذا فيحرق ليستبد ويسرق ، يحرق من أجل النسق أو الفسق ، لينضج نفاقا : الرفاه والشبق.
طين ذاك يحترق طينا آخر ، جسد هذا يحرق هو إذن قربان تأكله النار.
3 . الشعر مسلك وخلاص ، وقنطرة عبور لإطفاء الحريق ، عبر تسييد الهذيان.
بين حاء الحرقة التي تستنبتها حروف القريض منهجا وديدنا ، وحاء الاحتراق التي يتسيد فيها ” الآخر ” المعتدي ، قنطرة عبور يسلك عبرها المبدأ مغلفا بالحرف. لينشر صرخة امرأة شامية ، تستنجد الضمير المستتر الحي الغائب ، تطلب الواعي النائم أو المنوم ليحرك الفعل ، من أجل أن يتساوى الطين بالطين ، ويتسيد الأسمى والمعنى ، ويتداعى الجهل ويسقط العمى ، فيرتاح الميدان. لتهدأ النفس ويهنأ الوطن ، هي حفنة من تراب نثرت في وجه الطين ، لتغدو ريح مسك تغشى أوصاله كاملة ، نجيع دم ينعش التيبس والتكلس. فما الوطن ؟
أرض تقل وسماء تظل ، وحين تمد عينيك باحثا عن غد عصي ،متمنع قد يأتي ، ولكن بعد وجع مخاض لولادة عسيرة ، ترى زرقة السماء بعلوها وسموق شأنها ، وحسنها الذي تغنى له القريض ، تضاجع التراب وتعانق انحداره وسفالته ، وترضى بوضاعته ، حينها وحينها فقط يتشكل الوطن.
*********
هوامش :
*1. وفيق خنسة ، دراسات في الشعر السوري الحديث / دار الحقائق ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1981 . ص 76
*2. لعل القارئ يستنتج ارتباط الاحتطاب بالافتعال وإحالته دلاليا إلى المشاركة ، وربطه بافتعال الأشياء واختلاقها ، أو تحريكها بفعل فاعل خفي ، دسيسة أو مؤمرات ، وعلاقته بالاقتتال في الواقع السوري . “